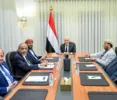- رئيس الوزراء اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأميركي تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
- قائد محور طور الباحة يمنع اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة سجون غير قانونية
- عدن.. مطالبات للحكومة بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بملف المخفيين قسرًا
- البرهان: لا هدنة مع من قتل ونهب وشرّد السودانيين
- اليمن.. أكثر من 18 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير الجاري
- اليمن.. صدور قرار جمهوري بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها
- مجلس القيادة الرئاسي يقر مقترح التشكيل الحكومي الجديد ويؤكد التزامه بدعم الحكومة
- شرطة تعز تسجل ضبط أكثر من 90% من الجرائم خلال يناير 2026
- اليمن.. آلاف المحتجين في سيئون يجددون "تفويضهم" للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل
- الأمم المتحدة تحذّر من تدهو الوضع الإنساني وتؤكد حاجة أكثر من 22 مليون يمني للمساعدات
شكَّل تصريح مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أدوي في الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مقاربة المنظمة القارية للحرب في السودان.
وقد جاء إعلانه عن أولوية قيادة الاتحاد الإفريقي لعملية السلام، هذه المرة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، تعبيراً عن السعي إلى المشاركة في الوساطة، وإيجاد موقع في المبادرات المتعددة، لا سيما أن المحاولات السابقة قد أسهمت في إرباك المشهد، وأضعفت فرص التوصل إلى مسار تسوية متماسك.
في هذا الإطار، يتحرك الاتحاد الإفريقي ضمن تصور يتجاوز الاكتفاء بالدور الدبلوماسي الشكلي، ويتجه نحو استعادة حضور سياسي وأمني فاعل في واحدة من أكثر أزمات القارة تعقيداً.
ويعكس هذا التوجه محاولة لإعادة بناء وزن مؤسسي تراجع تأثيره خلال السنوات الماضية، وعزمه على إدخال أدوات جديدة في التعاطي مع النزاع السوداني، تشمل التنسيق الأمني، والمتابعة السياسية، وربط مسارات التفاوض بسياق إقليمي أوسع، لكن هذا المسار يواجه قيوداً عملية واضحة، تتصل بضعف القدرات التنفيذية، وصعوبة تحويل البيانات والقرارات إلى أدوات ضغط ملموسة على طرفي الصراع.
وتزداد هذه التحديات حدة في بيئة إقليمية متشابكة، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تقديم نفسه إطاراً مرجعياً لجهود التسوية، من دون امتلاك رؤية جامعة أو وسائل كافية لفرض انضباط فعلي على مسار التفاوض، وليس كشريك في المبادرات التي قطعت شوطاً في اتجاه حل الأزمة، ولكن يطرح نفسه كبديل برؤية أحادية تحت شعار "حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية".
ونتيجة لذلك، تتسم تحركات الاتحاد الإفريقي بدرجة من الحذر المحسوب، وتندرج في سياق إعادة تموضع داخل مشهد معقد، أكثر من كونها تعبيراً عن قدرة مستقرة على إدارة مسار سلام شامل.
ويكتسب تنسيق الاتحاد الإفريقي مع الأمم المتحدة، ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، أهمية خاصة في إطار سعيه لمنح جهده غطاءً دولياً يحد من عزلته الأخيرة.
مع ذلك، تكشف مواقف مجلس السلم والأمن الإفريقي، خصوصاً بعد تطورات ميدانية خطرة مثل سقوط الفاشر وما رافقه من انتهاكات، عن فجوة قائمة بين الصلاحيات القانونية المتاحة، بما فيها آليات التدخل في حالات الجرائم الجسيمة، وبين الإرادة السياسية اللازمة لتفعيلها. وبين قرارات متكررة وتكليفات واسعة، يبقى التنفيذ بطيئاً، في وقت يواصل العنف فرض وقائعه.
إرث التردد
منذ اندلاع الحرب في السودان، بدا حضور الاتحاد الإفريقي محكوماً بإرث ثقيل من التردد المؤسسي، وحسابات التوازن بين مبدأ السيادة وواجب الحماية، أكثر مما كان مدفوعاً بإحساس الاستعجال الذي فرضه انهيار الدولة والعنف واسع النطاق.
ظل وضع السودان القانوني محكوماً بقرار تعليق مشاركة سلطاته في أنشطة الاتحاد الإفريقي منذ انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، وهو تعليق استمر مع اندلاع الحرب، من دون أن يعني خروج السودان من المنظمة القارية أو من الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، التي واصل التفاعل معها سياسياً ودبلوماسياً.
خلال الأشهر الأولى للحرب، اكتفى الاتحاد الإفريقي بمواقف حذرة، ركزت على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضبط النفس، واستئناف العملية السياسية، من دون أن يترجم ذلك إلى أدوات ضغط حقيقية على طرفي النزاع.
وعلى رغم إدانته المعلنة للعنف، ظل أداؤه بطيئاً مقارنة بحجم الكارثة الإنسانية، ومحدود التأثير في مسار العمليات العسكرية أو في حماية المدنيين.
كما أن علاقته بطرفي النزاع اتسمت ببراغماتية حذرة، إذ حافظ على قنوات تواصل مع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" في آن واحد، من دون أن ينجح في تحويل هذا التواصل إلى مسار تفاوضي فاعل أو التزام ملزم.
هذا الأداء المتحفظ فتح الباب أمام انتقادات واسعة من القوى السياسية والمدنية السودانية، التي رأت في موقف الاتحاد الإفريقي تعبيراً عن تقاعس أكثر منه حياداً. فقد وجهت له اتهامات بـ"بطء" الاستجابة، وبالارتهان لإجراءات بيروقراطية لا تتناسب مع حرب تتوسع جغرافياً وتنتج فظائع جماعية.
واعتبرت قوى مدنية أن تعليق عضوية السودان، من دون ابتكار أدوات تدخل سياسية وأمنية موازية، حول الاتحاد إلى مراقب عاجز، بينما كانت البلاد تنزلق إلى واحدة من أسوأ أزماتها منذ الاستقلال.
حتى عندما نشط مجلس السلم والأمن في عقد جلسات طارئة، وإصدار بيانات متلاحقة، ظل الانطباع السائد أن القرارات تراكم على الورق أكثر مما تنفذ على الأرض.
فالتوصيات المتعلقة بحماية المدنيين، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وملاحقة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، بقيت في معظمها حبراً على ورق، أو رهينة جداول زمنية لم تحترم.
وعليه، فإن التحرك الأخير للاتحاد الإفريقي، والدعوة إلى قمة رئاسية مرتقبة في شأن السودان، يقرآن على خلفية هذا السجل المثقل بالخطوات البطيئة.
فهو لا يمثل نقطة بداية، بقدر ما يشكل محاولة متأخرة لتدارك فجوة الصدقية التي اتسعت بين المؤسسة القارية وفاعليها المفترضين في السودان، وبين خطاب القيادة الإفريقية وواقع عجزها الطويل عن تحويل النفوذ الأخلاقي إلى فعل سياسي حاسم.
اقتناص الفرصة
يبرز الموقف الأخير للاتحاد الإفريقي من الأزمة السودانية كحصيلة تراكم ضغوط داخلية وخارجية تلفت إلى ضرورة صياغة دور يتناسب مع مؤسسة قارية تأسست منذ نحو ستة عقود.
فالتحول الأبرز يتمثل في انزياح واضح في الخطاب، من الاكتفاء بنداءات وقف إطلاق النار والتهدئة، إلى إعلان صريح عن نية قيادة العملية السياسية نفسها.
هذا التحول يعكس اعترافاً ضمنياً بفشل محاولات تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، في أشد الأوقات التي كان يحتاج إليها، مع أن دول إفريقية أخرى مرت بظروف السودان ذاتها، ولم تعلق عضويتها.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة الخطاب الجديد بمعزل عن رسالة موجهة إلى القوى الدولية. فتأكيد "القيادة الإفريقية" المقترنة بتنسيق منظم مع الأمم المتحدة، يحمل معنى مزدوجاً، وهو قبول بالشراكة الدولية من جهة، ورفض صريح لما يعتقد أنه إزاحة الملف السوداني خارج الفضاء الإفريقي من جهة أخرى.
هنا يسعى الاتحاد إلى إعادة تعريف دوره من وسيط محايد إلى فاعل سياسي جيواستراتيجي، وصل أخيراً إلى نتيجة أن الحرب في السودان لم تعد شأناً داخلياً، بل عقدة أمنية تهدد القرن الإفريقي والساحل والبحر الأحمر.
فوصل إلى استدراك، أن ترك هذا النزاع من دون إطار إفريقي جامع يعني فتح المجال أمام تدخلات منافسة تدار من خارج الإقليم، وتدار وفق أولويات لا تنسجم بالضرورة مع الاتحاد الإفريقي.
كذلك فإن توقيت هذا التحرك لا ينفصل عن تحولات أوسع في البيئة الدولية، فعلى رغم أن الحرب بلغت ذروات غير مسبوقة من العنف، خصوصاً في دارفور، وامتدادها نحو كردفان، فإن الاهتمام الدولي ظل متذبذباً، ومتراجعاً مقارنة بأزمات أخرى أكثر حضوراً في الأجندات العالمية.
هذا التهميش خلق فراغاً سياسياً خطراً، جعل الاتحاد الإفريقي أمام خيارين، إما القبول بدور المتفرج، أو محاولة ملء الفراغ بحد أدنى من المبادرة.
غير أن المتغير الحاسم جاء مع عودة الملف السوداني إلى دائرة الاهتمام الأمريكي، في ظل توجه واضح من إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو تحريك مسار الحل، بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن وطرحه الأزمة السودانية كقضية إقليمية عاجلة.
هذا الزخم أعاد الاعتبار للملف، وخلق نافذة سياسية أدرك الاتحاد الإفريقي أنها قد لا تتكرر.
فالمبادرة في هذه اللحظة لا تعني فقط استثمار الاهتمام الدولي، بل السعي لتوجيهه ضمن إطار إفريقي، اقتناصاً لفرصة قد يتحقق عندها ربط السلام في السودان بمعادلاته الإقليمية.
تحديات ماثلة
أول التحديات التي يواجهها الاتحاد الإفريقي في محاولة توليه زمام القيادة في المشهد السوداني يتمثل في فجوة الصدقية التي راكمها الاتحاد منذ اندلاع الحرب، إذ يصعب على مؤسسة اتهمت طويلاً بالبطء والتردد أن تنتقل فجأة إلى موقع القيادة من دون أن تواجه شكوكاً عميقة لدى الفاعلين السودانيين، خصوصاً القوى المدنية التي خبرت بيانات كثيرة ونتائج قليلة.
يتصل بذلك تحدي النفوذ المحدود على طرفي النزاع، فالاتحاد الإفريقي يفتقر إلى أدوات ضغط مباشرة وفعالة تجبر القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" على الالتزام بوقف النار أو الدخول في مسار تفاوضي جاد.
غياب العقوبات الرادعة، وضعف القدرة على فرض إجراءات تنفيذية، يجعلان دوره رهيناً بحسن نية أطراف أثبتت الحرب أنها لا تستجيب إلا لموازين القوة.
وفي ظل استمرار تدفق الدعم الخارجي غير المنضبط، يصبح أي مسار تقوده المنظمة القارية عرضة للتآكل من الخارج قبل أن ينضج من الداخل.
ويواجه الاتحاد تحدي التشظي الإقليمي ذاته، فالقارة التي يسعى الاتحاد إلى توحيد موقفها تعاني تبايناً حاداً في أولويات دولها تجاه السودان، بعضها ينظر إلى الحرب من زاوية أمن الحدود، وبعضها من منظور التنافس الجيوسياسي، وآخرون من حسابات النفوذ الاقتصادي. هذا التباين يضعف القدرة على بلورة موقف أفريقي صلب، ويجعل القيادة القارية عرضة للتجاذب بين عواصم متنافسة.
ولا يقل تعقيد المشهد الداخلي السوداني تحدياً عن الإقليم، فقيادة عملية السلام تتطلب فهماً دقيقاً لخريطة القوى المدنية، التي باتت منقسمة ومنهكة، وتفتقر إلى مركز ثقل موحد. وإعادة إدماج هذه القوى في عملية سياسية ذات معنى، من دون أن تتحول إلى مجرد غطاء مدني لتسوية عسكرية، تمثل معضلة حقيقية أمام أي وسيط، ناهيك بمؤسسة قارية محدودة الموارد.
يضاف إلى ذلك تحدي الانتقال من الوساطة إلى الفعل التنفيذي، فقيادة المشهد لا تعني جمع الأطراف فحسب، بل تتطلب القدرة على حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. وهنا يصطدم الاتحاد الإفريقي بضعف بنيته التنفيذية، وبفجوة واضحة بين طموح الخطاب وإمكانات التطبيق.
مستقبل السعي
تفتح تحركات الاتحاد الأفريقي الأخيرة تجاه الأزمة السودانية أفقاً يتجاوز سؤال النجاح أو الإخفاق الآني، إلى اختبار أعمق يتعلق بمستقبل الدور القاري ذاته في إدارة النزاعات المعقدة. فالسودان لم يعد مجرد ساحة حرب داخلية، بل عقدة إقليمية تتقاطع فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، مما يجعل أي مسعى للحل مرهوناً بقدرة الفاعلين على تنسيق الجهود لا مزاحمتها.
وترتبط آفاق هذا الدور بمدى وعي الاتحاد بطبيعة وحدود قدرته، فمحاولته الانتقال إلى موقع "قائد مبادرة سلام" تتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين المسار السياسي والترتيبات الأمنية، وحماية المدنيين، ومعالجة الاقتصاد الحربي، والحد من تدفقات السلاح والدعم الإقليمي.
هذا الإدراك يمنح المبادرة المطروحة قيمة نوعية، غير أن تحويله إلى نتائج عملية يظل مرتبطاً بعوامل بنيوية، في مقدمها محدودية التمويل والقدرات اللوجيستية، وضيق أدوات الضغط المباشر على طرفي الصراع.
من هنا، تتشكل معادلة النجاح الواقعية عبر التكامل مع جهود "الرباعية"، التي بدأت انتظامها المبكر بجدية أكبر، وامتلكت شبكات نفوذ دولية وأدوات اقتصادية وسياسية أوسع.
هذا التكامل لا يضع الاتحاد في موقع التابع بل يمنحه فرصة لعب دور المنسق القاري، القادر على توحيد المسارات، وتوفير الشرعية الإفريقية، وربط المبادرات الدولية بسياق إقليمي على صلة بتعقيدات المجتمع السوداني وبنيته السياسية.
وعندما تدار العلاقة على هذا الأساس، تتحول الفجوة في الإمكانات إلى توزيع أدوار، ويصبح نقص الموارد عاملاً محفزاً للشراكة لا عائقاً أمامها.
السودان، في هذا الإطار، يمثل اختباراً عملياً لفكرة العمل المتعدد الأطراف تحت قيادة إفريقية، فنجاح الاتحاد في جعل جهوده مكملة للرباعية سيحد من ازدواجية المنصات، ويقلص تناقض الأجندات، ويمنح العملية السياسية زخماً واستمرارية. كما أن هذا النموذج، إذا ترسخ، سيعيد تشكيل مقاربة إدارة النزاعات في القارة، ويؤسس لفهم جديد لدور الاتحاد.
مستقبل سعي الاتحاد الإفريقي في السودان، إذاً، يتحدد بقدرته على تحويل الطموح السياسي إلى شراكات فعالة، وعلى إدراك أن القيادة في النزاعات المعقدة تقوم على جمع القوى لا احتكارها. وعند هذه النقطة، يصبح النجاح ممكناً، ليس فقط في السودان، بل كنموذج قاري قابل للتكرار في أزمات إفريقية أخرى.