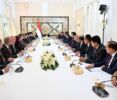- محافظ شبوة يشكّل لجنة تحقيق في ملابسات أحداث عتق الأخيرة
- مأرب.. لقاء نسوي لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي ومسارات السلام
- اللجنة الوطنية للتحقيق تزور عددًا من مراكز الاحتجاز في محافظة شبوة
- اليمن.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في صدامات بمدينة عتق بمحافظة شبوة
- بدعم سعودي.. بدء مرحلة جديدة من توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر- مأرب
- العليمي يحذّر من التعاطي مع الحوثيين كـ"فاعل طبيعي" ويؤكد أن ذلك يكرّس دوامة الصراع والمعاناة باليمن
- السلطات في محافظة المهرة تضبط مطلوبًا أمنيًا في قضايا اختطاف وابتزاز
- علي لاريجاني يلتقي رئيس وفد الحوثيين في مسقط ويبحث معه التطورات الإقليمية
- وفد من الأمم المتحدة يبحث مع خفر السواحل اليمنية تعزيز الأمن البحري ومكافحة الجريمة
- لجنة التحقيق تطّلع على أوضاع المحتجزين على ذمة الحرب باللواء 35 مدرع بتعز
مع تصاعد العمليات العسكرية، شهد إقليم النيل الأزرق منعطفاً أعاد رسم ملامح المشهد الأمني في جنوب شرقي السودان، ففي مطلع فبراير/ شباط الجاري نفذت قوات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية- شمال"، جناح عبدالعزيز الحلو، هجوماً منظماً على ثلاثة مواقع حيوية في الإقليم، أسفر عن السيطرة على بلدة ديم منصور ذات القيمة الاستراتيجية العالية، بوصفها معبراً مؤثراً في خطوط الإمداد والحركة بين الداخل والحدود.
وجاءت العملية بعد أيام من استعادة الجيش السوداني مواقع في محافظة باو، إثر تحرك عسكري انطلق من أراضي دولة جنوب السودان، في مشهد يعكس تداخل المسارات القتالية في الإقليم عبر الحدود.
ورافقت الهجوم روايات عن الاستيلاء على مركبات قتالية ودبابات وطائرات مسيّرة، بما يعكس سعي "الدعم السريع" إلى تحقيق مكاسب نوعية يمكن أن ترجح كفة الصراع على المدى المتوسط.
وقبل ذلك، صباح الـ25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، اندلعت جولة عنيفة من الاشتباكات عند المحور الجنوبي للولاية حول منطقتي السلك وملكن، وهما نقطتان تشكلان عقدة جغرافية وعسكرية شديدة الحساسية بحكم قربهما من الحدود وتشابك البنى القبلية ومسارات الحركة المسلحة فيهما، مما منح المعارك بعداً إقليمياً، وأضفى عليها طابعاً يتجاوز حدود الولاية نحو حسابات أوسع.
واتخذ الهجوم طابعاً منسقاً منذ ساعاته الأولى، مع اعتماد قوات متحركة تستخدم عربات خفيفة عالية المناورة، مدعومة بتغطية مكثفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتمثل الهدف في الضغط على انتشار الجيش السوداني حول القرى والطرق الحيوية المؤدية إلى العمق الإداري للإقليم، واستمرت الاشتباكات قرابة ساعتين وشهدت كثافة في تبادل النيران، قبل أن يعلن الجيش احتواء الموقف ودفع القوات المهاجمة إلى التراجع.
وتعكس هذه الأحداث صراعاً تشكله جغرافيا معقدة وأطراف عدة، فيغدو إقليم النيل الأزرق مسرحاً آخر للمواجهات الحدودية.
نقل المواجهة
يكتسب ما جرى في بلدة ديم منصور دلالة تتجاوز حدود الاشتباك التكتيكي، ليقع في صميم الجغرافيا السياسية للصراع السوداني، فالبلدة لا تختزل في موقعها، بل في وظيفتها بوصفها عتبة متقدمة تحمي مدينة الكرمك، آخر الحصون الحضرية الكبرى للجيش في هذا القطاع الحدودي.
ويمكن أن يفتح سقوطها المحتمل فراغاً عملياتياً يهدد بانكشاف كامل المحور الشرقي للنيل الأزرق، ويعيد للذاكرة سرديات قديمة لم تغلق فصولها بعد.
ونُفذ الهجوم الذي استمر لساعات بقوة كبيرة مدعومة بالطائرات المسيّرة، ويشير تدمير مخازن الذخيرة والآليات العسكرية إلى منطق استنزاف محسوب، يسعى إلى إضعاف البنية القتالية قبل فرض وقائع ميدانية أوسع.
وتعكس المقاطع المصورة التي بثتها "الحركة الشعبية- شمال" وما أظهرته من تحصينات ومدافع ثقيلة داخل خنادق محاولة للسيطرة، مقابل إضافة طبقة أخرى من الغموض الاستراتيجي إلى المشهد.
ويفسر تاريخ الكرمك وقيسان كثيراً من هذا الاهتمام، فقد تحولت المدينتان خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى عقدتي عبور بين الشمال والجنوب ومختبر مبكر لاستراتيجية الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق التي قامت على السيطرة على الأطراف لفرض كلمتها على المركز.
ورسخت تلك التجربة حقيقة أن من يمسك بهذه الجغرافيا لا يربح معركة معزولة، بل يمتلك قدرة على التأثير في توازنات أوسع، سياسية وعسكرية معاً.
ويُقرأ التحرك الحالي ضمن استراتيجية "الدعم السريع" الرامية إلى إعادة توزيع الضغط عبر نقل ثقل المواجهة إلى مناطق حدودية ذات حساسية عالية، بما يخفف العبء عن جبهات دارفور وكردفان، ففتح جبهة في النيل الأزرق في هذا التوقيت لا يخدم هدف السيطرة المباشرة وحسب، بل يفرض على الجيش معادلة انتشار مرهقة، تستنزف فيها الموارد على مسارح متباعدة.
وإشراك "الحركة الشعبية- شمال" يمنح العملية بعداً مركباً يعيد إحياء تحالفات الهامش المسلحة، ويبعث بإشارة واضحة إلى أن الصراع يتجه نحو إعادة رسم خرائط النفوذ القديمة. واختيار هذا المحور يعكس فهماً لوظيفة الإقليم بوصفه بوابة مفتوحة على جنوب السودان وإثيوبيا، ومجالاً تقليدياً للحركة والتموضع.
نمط متكرر
يمكن قراءة سلوك قوات "الدعم السريع" على تخوم السودان على أنه تعبير عن منطق يقوم على استثمار الهشاشة الإقليمية بوصفها مورداً عسكرياً وسياسياً في آن واحد، فالجغرافيا الحدودية في هذا التصور لا تُعد أطرافاً بعيدة من مركز الصراع، بل مساحات مرنة لإعادة تشكيل ميزان القوة، فتختلط السيادة بالفراغ، وتتحول الدولة المجاورة إلى امتداد غير معلن لساحة العمليات.
وتكشف تجارب الأعوام الماضية عن نمط متكرر، فعلى الحدود مع تشاد، شكلت المناطق الصحراوية المفتوحة مسرحاً لحركة القوات وتبدل مواقعها، مستفيدة من تاريخ طويل لتداخل القبائل وخطوط التهريب.
وهناك كانت الهجمات أيضاً جزءاً من ديناميكية أوسع تسمح بإعادة التموضع وتخفيف الضغط عن الجبهات الداخلية.
والمشهد ذاته تكرر على الحدود مع إفريقيا الوسطى، حيث أشير إلى وجود معسكرات تستخدم لأغراض التدريب والإمداد، في فضاء تغيب عنه الرقابة الصارمة وتضعف فيه قدرة الدولة على فرض السيطرة.
وعلى الجبهة الجنوبية مع دولة جنوب السودان، اتخذت الاستراتيجية بعداً أكثر تعقيداً، فهذه الحدود ليست مجرد خط جغرافي، بل إنها حقول نفط ملتهبة ومتنازع عليها وإرث حرب طويلة ومسار علاقات متشابكة بين حركات مسلحة وفاعلين محليين.
والآن، ينتقل هذا المنطق إلى جنوب شرقي السودان حيث الحدود مع إثيوبيا، والتقارير التي تتحدث عن معسكر حديث لتدريب قوات "الدعم السريع" داخل الأراضي الإثيوبية تعزز صورة نمط متدرج، كلما اشتد الضغط في الداخل، اتسعت الدائرة نحو الخارج.
وهذه الحدود، بما تحمله من تعقيد سياسي وأمني، توفر بيئة ملائمة لإعادة الانتشار وتأمين مسارات إمداد بديلة، في لحظة تشهد فيها المنطقة سيولة أمنية لافتة.
ضمن هذا الإطار، تبدو تحركات "الدعم السريع" أقل ارتباطًا بخرائط السيطرة المباشرة، وأكثر التصاقاً بفكرة الاستنزاف طويل الأمد، إذ إن فتح جبهات حدودية متزامنة يفرض على الجيش السوداني معادلة انتشار مرهقة، تستنزف فيها الموارد وتتشتت فيها الأولويات.
ويعكس هذا النمط حقيقة طبيعة الدولة السودانية وحدودها، حيث تتحول الأطراف إلى مركز ثقل حاسم، وفي هذا السياق تصبح الحدود المتوترة أداة استراتيجية بحد ذاتها، لا مجرد مسرح جانبي، ويغدو الإقليم المحيط بالسودان جزءاً من معادلة الحرب، لا هامشاً لها.
هشاشة أمنية
يمكن مقاربة ما يجري في إقليم النيل الأزرق بوصفه لحظة كاشفة لمنطق أوسع يحكم تفاعلات القرن الإفريقي، حيث تتحول الحدود من خطوط فاصلة إلى مساحات اختبار، وتغدو الجغرافيا عامل ضغط لا يقل وزناً عن القوة العسكرية نفسها.
فالنيل الأزرق، بحكم موقعه عند تقاطع السودان وإثيوبيا وجنوب السودان، لا يؤدي وظيفة العبور فقط، بل يقوم بدور الرافعة الاستراتيجية التي تسمح لمن يملك النفوذ فيه بتوسيع هامش المناورة، سياسياً وعسكرياً، في إقليم يتسم بهشاشة أمنية مزمنة.
وتزامن التصعيد في إقليم النيل الأزرق مع تجدد التوترات في إقليم تيغراي، مما يعكس ترابط الأزمات في القرن الإفريقي، حيث لا تتحرك الصراعات في مسارات منفصلة، بل تتغذى على بعضها، فعدم الاستقرار في إثيوبيا سواء في تيغراي أو أمهرة يخلق فراغات أمنية قابلة للتسييس والعسكرة، مما ينعكس مباشرة على الجوار السوداني.
وفي هذا السياق، تبدو العلاقة السودانية- الإثيوبية محكومة بمواجهات مقبلة، خصوصاً مع إنكار أديس أبابا التدخل في الحرب السودانية، فيما ظلت الخرطوم تنظر بعين الشك إلى التحركات العسكرية القريبة من حدودها الشرقية.
والاتهامات السودانية بتسهيل مرور قوات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية- شمال" عبر إقليم بني شنقول قمز واستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من داخله يضعان إثيوبيا أمام معضلة استراتيجية حقيقية. فحتى على افتراض أن هذه التحركات تخدم حسابات ظرفية، فإن كلفتها المحتملة تفوق مكاسبها، إذ إن بني شنقول قمز منطقة حساسة تتقاطع فيها الهويات والهشاشة الأمنية، وتقع في محيط "سد النهضة"، أحد أهم المشاريع السيادية الإثيوبية.
والأخطر أن أي تدخل غير مباشر في تدريب أو إيواء قوة سودانية مسلحة ينعكس داخلياً على إثيوبيا نفسها، ولا سيما في ظل تمرد ميليشيات فانو في إقليم أمهرة التي تخوض صراعاً مفتوحاً مع الحكومة الفيدرالية، ووجود معسكرات تدريب لقوة أجنبية مسلحة يمنح خطاب فانو ذريعة إضافية لتصعيد تمردها، ويشجع ميليشيات أخرى مثل العفر على التمسك بالسلاح ورفض الاندماج.
من هذا المنظور، يتحول إقليم النيل الأزرق من ساحة صراع سودانية داخلية إلى مرآة تعكس هشاشة الإقليم بأسره. فإثيوبيا، إذا ما انزلقت إلى لعبة الحدود الرمادية، ستكون أول المتضررين، سواء عبر اتساع التمردات الداخلية أو عبر تهديد غير مباشر لأمن "سد النهضة" نفسه.
وضمن القرن الإفريقي، لا يمكن فصل الأمن عن الجغرافيا، ولا الجغرافيا عن السياسة، وكل محاولة لاستخدام الأطراف كساحات نفوذ سرعان ما ترتد إلى القلب.
مسارات محتملة
يمكن قراءة المرحلة المقبلة من الصراع في إقليم النيل الأزرق بوصفها انتقالاً من الاشتباك المباشر إلى إدارة صراع ممتد، تتحكم فيه الجغرافيا والحدود بقدر ما تتحكم فيه القوة العسكرية.
فالمعركة لم تعُد مسألة تقدم ميداني سريع، بل باتت اختباراً لقدرة كل طرف على صياغة استراتيجية قادرة على الصمود في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
بالنسبة إلى الجيش السوداني، تلوح ملامح استراتيجية تقوم على إعادة ضبط الإيقاع بدلاً من السعي إلى حسم خاطف، والهدف الأول يتمثل في احتواء التمدد عند المحاور الحساسة، وعلى رأسها محيط الكرمك، عبر بناء خطوط دفاع متدرجة تحوّل أي هجوم إلى عبء استنزافي على القوة المهاجمة.
وهذا التوجه الدفاعي لا ينفصل عن بعد اجتماعي موازٍ، إذ يصبح تثبيت التحالفات المحلية واحتواء التوترات القبلية عنصراً حاسماً في منع اختراق العمق، وتقليص قدرة "الحركة الشعبية- شمال" على استثمار الهشاشة الداخلية.
ويتكامل هذا المسار مع مقاربة سياسية وأمنية للحدود الشرقية، حيث يسعى الجيش إلى رفع كلفة أي تدخل غير مباشر عبر أدوات دبلوماسية محسوبة، من دون الانجرار إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
في هذا الإطار، تتحول العلاقة مع إثيوبيا إلى جزء من معادلة الردع، لا مجرد ملف ثنائي، ويغدو الضغط السياسي امتدادًا للمعركة على الأرض.
في المقابل، تقوم استراتيجية تحالف "الدعم السريع" وقوات عبدالعزيز الحلو على كسر هذا الاحتواء من خلال توسيع رقعة الصراع، وفتح جبهة النيل الأزرق يأتي في سياق نقل الضغط من مسارح القتال التقليدية إلى مناطق حدودية ذات حساسية عالية، بما يفرض على الجيش تشتيت موارده وإعادة توزيع قواته.
ويترافق هذا التوسع مع الاعتماد على شبكات حركة وإمداد عابرة للحدود، تمنح التحالف مرونة تكتيكية وقدرة على المناورة في فضاء إقليمي مفتوح.
ويمنح إشراك "الحركة الشعبية- شمال" هذا التحرك بعداً سياسياً إضافياً، يعيد إحياء تحالفات الهامش المسلحة، ويحوّل الصراع من مواجهة ثنائية إلى مشهد أكثر تركيباً، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع رسائل سياسية موجهة إلى الداخل والخارج.
في ضوء هذه المعادلات، تبرز ثلاثة مسارات محتملة، انسداد استراتيجي تتجمد فيه الجبهات من دون حسم واضح، أو تصعيد إقليمي محدود تغذيه هشاشة الحدود وتداخل الصراعات، أو انفتاح مسار تفاوضي تفرضه كلفة الاستنزاف على جميع الأطراف. وبين هذه الاحتمالات، يبقى إقليم النيل الأزرق نقطة توازن دقيقة، تدار فيها الحرب بوصفها صراعاً على الزمن بقدر ما هي صراع على الأرض.
(اندبندنت عربية)